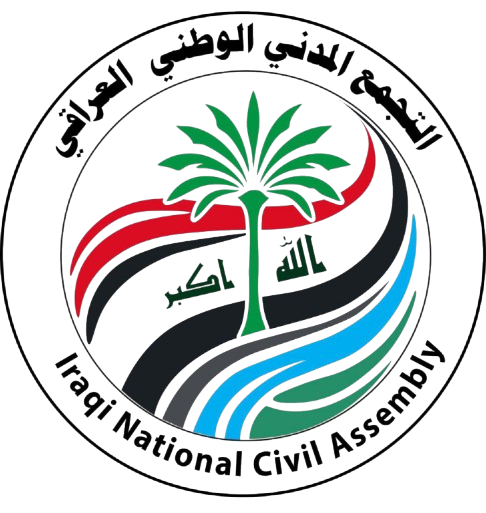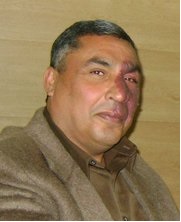انتخابات 2010 في العراق: بداية الانحدار في شرعية العملية السياسية
مقالات
الدكتور رافع سحاب احمد الكبيسي
ما جرى في عام 2010 حين انقلبت السياسة على صناديق الاقتراع، و انكسر العقد الديمقراطي، وحين اتت المحكمة الاتحادية تفسيرا مخالف لمسار الديمقراطية، يمثل بعد خمسة عشر عاماً على السرقة السياسية الكبري التي غيرت المسار السياسي في العراق.
شكّلت انتخابات عام 2010 واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ العراق ما بعد 2003، ليس فقط بسبب نتائجها، بل بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع تلك النتائج، والتي أسست لاحقاً لما يمكن تسميته بأزمة الثقة البنيوية في جوهر العملية السياسية العراقية.
فقد فازت “القائمة العراقية” التي ترأسها الدكتور إياد علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعداً، متقدمة بمقعدين على “ائتلاف دولة القانون” الذي حاز 89 مقعداً. هذا الفوز، وبحسب المادة (76) من الدستور العراقي، يمنح الكتلة الفائزة الحق الدستوري في تشكيل الحكومة. لكن ما حدث بعد الانتخابات كان انقلاباً سياسياً ناعماً على هذا الاستحقاق.
فبتفسير مثير للجدل تبنته المحكمة الاتحادية العليا، اعتُبرت “الكتلة الأكبر” هي تلك التي تتشكل داخل البرلمان بعد الانتخابات، وليس التي تفوز فيها. هذا القرار – الذي جاء بعد ضغوط سياسية وإقليمية كثيفة – أعاد تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة، رغم أن قائمته لم تحصد الأغلبية في صناديق الاقتراع.
وقد علّق الدكتور إياد علاوي حينها في مقابلات صحفية قائلاً:
“لقد سُرق النصر الانتخابي منا، وما جرى لم يكن إلا خرقاً صريحاً للدستور وخيانة لإرادة الناخب العراقي.”
كما صرّح لاحقًا في لقاء مع قناة CNN:
“ما حدث بعد انتخابات 2010 وجه ضربة قاسية لثقة المواطن العراقي بالعملية الديمقراطية، وأعاد تكريس وتعميق الفساد الاداري والمالي وتكرست الطائفية السياسية وضعفت رح والمواطنة”.
ردود الفعل الدولية لم تكن غائبة، إذ أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عن قلقها من تأخير تشكيل الحكومة، وأشارت تقارير إعلامية آنذاك إلى أن الولايات المتحدة مارست دورًا ضاغطًا خلف الكواليس لصالح المالكي، تحت مبررات “الاستقرار”، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي وأثار تساؤلات عن حدود السيادة في القرار الوطني العراقي.
ولقد كان للابتزاز الايراني تأثيره على الانتخابات العراقية 2010، فبحسب ما اورده بن رودس، المستشار المقرب للرئيس الامريكي باراك اوباما، فإن فوز اياد علاوي في انتخابات 2010 ازعج طهران الى درجة كبيرة، هدد الايرانيون آنذاك بـ”وقف المفاوضات النووية السرية” مع واشنطن اذ اصبح علاوي رئيساً للوزراء، وطالبوا اوباما بالتدخل لدعم نوري المالكي بدلاً منه –وهو ما حدث فعلاً لاحقاً،
ويضيف رودس أن الاتفاقات الأميركية – الإيرانية المبرمة منذ عام 2010 أدّت إلى رفع العقوبات عن طهران ودعم نفوذها ماليا وسياسيا، ما مكنها من ممارسة ضغوط مباشرة لتثبيت موضعها في الحكم السياسي العراقي، عبردفع إدارة أوباما لتشجيع تكليف المالكي بتشكيل الحكومة، رغم أن القائمة العراقية بقيادة علاوي هي التي فازت بالانتخابات.
كما يكشف رودس أن المالكي هومن أعطى الأمربفتح السجون لتهريب عملاء إيران من تنظيم “القاعدة“، الذين أسندت إليهم لاحقا مهمة تأسيس تنظيم “داعش.” وهو، بحسب رواية رودس، من أمرالجيش بالانسحاب من الموصل عمدا، وترك عتاد عسكري تزيد قيمته على 20 مليار دولار، إضافة إلى إبقاء مبلغ 600 مليون دولارفي فرع البنك المركزي بالموصل، مما مكّن نحو 600 عنصر من داعش من السيطرة على المدينة عام 2014، والحصول على الأموال والعتاد اللازمين لبدء مسلسل داعش – إيران، بما يخدم أجندات طهران الإقليمية.
لقد ترك هذا الحدث أثراً عميقاً في وجدان الناخب العراقي، وأسّس لانعدام الثقة المتنامي في الانتخابات كوسيلة حقيقية للتغيير. فالشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع مؤملاً أن صوته سيصنع الفارق، صُدم بأن النتائج لا تُحتَرَم إلا حين تكون لصالح القوى المتنفذة، وأن الصناديق قد تُفتح، لكن القرار الحقيقي يُتخذ في الغرف المغلقة، لا في مراكز الاقتراع.
منذ تلك اللحظة، بدأت العملية السياسية تفقد مشروعيتها الأخلاقية، وبدأت طبقة واسعة من العراقيين ترى أن الانتخابات مجرد واجهة شكلية تعيد إنتاج نفس الوجوه، مهما كانت نتائج التصويت. وقد انعكس ذلك في تراجع نسب المشاركة في الانتخابات اللاحقة، لا سيما في 2014 و2018، وارتفاع أصوات المقاطعة الشعبية والاحتجاجات.
إن ما جرى في انتخابات 2010 لا يمكن اعتباره حدثاً عابراً في تاريخ العراق السياسي، بل هو أحد الجذور الأساسية لحالة الفشل التي تعيشها العملية السياسية اليوم. فحين يُسلب المنتصر حقه الشرعي، وتُدار البلاد على قاعدة المغالبة لا الشراكة، فلا عجب أن تنهار الثقة، وتُصاب الديمقراطية بالتكلس، ويُترك الباب مشرعاً أمام الفوضى والتدخلات الخارجية.
لقد كان فوز إياد علاوي في 2010 فرصة حقيقية لبناء توازن سياسي جديد، يخفف من حدة الاستقطاب الطائفي، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني العابر للهويات الفرعية. لكن تلك الفرصة ضاعت، ليس بسبب صناديق الاقتراع، بل بسبب القوى التي رفضت الاعتراف بنتائجها، وما زالت حتى اليوم تمسك بخيوط اللعبة، رغم كل ما أفرزته من أزمات.
ولذلك، فإن أي حديث عن إصلاح حقيقي في العراق لا يمكن أن يكتمل من دون مواجهة هذا الإرث، والاعتراف بأن بناء ديمقراطية حقيقية يبدأ أولاً من احترام نتائج الانتخابات، ومنح الفائزين فرصة حقيقية لتقديم نموذج حكم مختلف. فما لم تُصحّح هذه المسارات، ستبقى العملية السياسية العراقية رهينة الشك، وتبقى صناديق الاقتراع مجرد أدوات تجميل لواقع سياسي مأزوم.