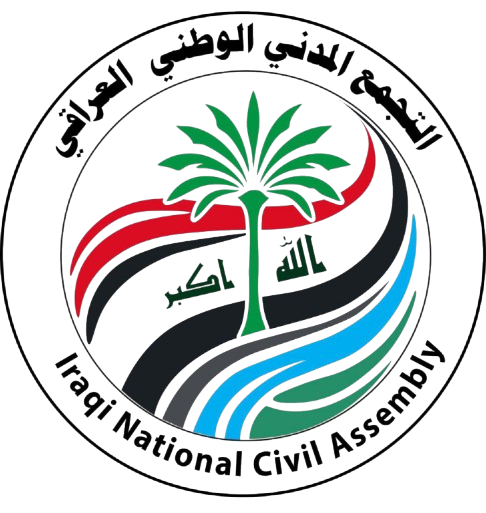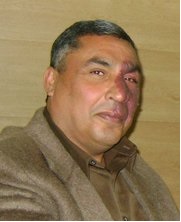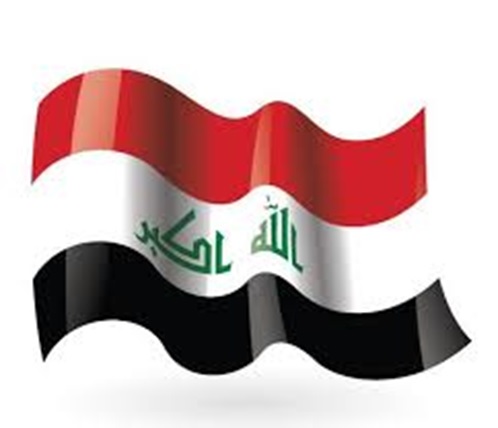
أزمة الانتماء الوطني في العراق
مقالات
د. زين العابدي الوائلي ــ البصرة
المقدمة
منذ عام 2003، يشهد العراق تحولًا خطيرًا في طبيعة الولاء والانتماء السياسي والاجتماعي، تجسّد في بروز ظاهرة الولاء الخارجي، وبشكل خاص لإيران ومرجعياتها الشيعية الطائفية.
هذه الظاهرة لم تعد حكرًا على النخب السياسية والدينية فحسب، بل تغلغلت إلى أعماق المجتمع، وخصوصًا في مناطق الوسط والجنوب، حتى باتت تهدد الهوية الوطنية العراقية، وتُشكك في مفاهيم السيادة والانتماء والولاء للدولة.
هذه الورقة تسعى إلى تحليل الجذور النفسية والاجتماعية والسياسية لهذا الانتماء الخارجي، وتحديد مخاطره البنيوية على مستقبل العراق كوطن حر، ودولة جامعة.
أولًا: التبعية لإيران ومرجعياتها المذهبية
إن مشهد الولاء لإيران والتبعية لمرجعياتها الدينية لم يعد مجرد خيار سياسي، بل أصبح عند شريحة واسعة من العراقيين مكوّنًا من مكونات الهوية العقائدية والاجتماعية، وهو ما يتجلى في تمجيد “الولي الفقيه”، وتقديم “تكليفاته الشرعية” على متطلبات السيادة الوطنية.
وقد عملت مؤسسات الحوزة، وأحزاب الإسلام السياسي، والميليشيات الولائية على إنتاج وعي جماهيري يرى في العراق مجرد “ساحة لخدمة المشروع الإلهي”، و”خط دفاع عن الجمهورية الإسلامية”، وليس وطنًا قائمًا بذاته.
ثانيًا: عقدة النقص أمام الآخر الشيعي الأقوى
تُظهر الدراسات النفس–سياسية أن كثيرًا من فئات المجتمع العراقي، وخصوصًا في الجنوب، باتت تنظر إلى إيران بوصفها النموذج الشيعي الأعلى، والمرجعية السياسية الأكثر تنظيمًا وقوة.
ويُعزز هذا الانطباع خطاب يتكرر منذ 2003، مفاده أن “العراق الشيعي محروم”، و”أن طهران انتصرت للمظلومين”، ما يزرع في النفوس عقدة نقص دفينة تؤسس للتبعية الطوعية.
ثالثًا: الانتهازية السياسية وتبدل الأقنعة
في النظام السياسي العراقي بعد الاحتلال، ظهرت طبقة كاملة من السياسيين الذين يتنقلون في ولاءاتهم بين طهران وواشنطن، حسب المصالح.
الكثير من هؤلاء يقدّمون “التمذهب” كبطاقة عبور سياسي، لكنهم يستثمرونه لأغراض مادية وشخصية. لا الوطن يعنيهم، ولا الدين يردعهم، بل الكرسي والامتياز.
رابعًا: تفكك الهوية الوطنية أمام المذهب والدين السياسي
من أخطر نتائج الاحتلال ونظام المحاصصة أن الهوية العراقية الجامعة تفككت لصالح الهويات المذهبية والمناطقية.
أصبح الولاء للمرجعية، أو للزعيم الميليشياوي، أو للسفارة، أقوى من الولاء للدولة. يُربّى الجيل على أن الطاعة للمرجعية أولى من خدمة الشعب، وأن العراق مجرد “جغرافيا مرنة” في مشروع ديني–سياسي عابر للحدود.
خامسًا: عقلية النهب والامتياز لا الانتماء
في ظل دولة ريعية منهارة، تحوّل العراق لدى كثيرين إلى مورد مالي لا أكثر.
المنفعة قبل المبادئ، والمخصصات قبل الهوية.
يُنهب المال العام، وتُباع العقارات العامة، وتُنقل الآثار، ويتم توقيع عقود تخدم الخارج، دون أي إحساس بالخيانة، لأن العراق في لاوعي هؤلاء لا يُنظر إليه كوطن، بل كغنيمة.
سادسًا: غياب المرجعية الوطنية
لا يمكن بناء وطن دون وجود مرجعية وطنية مستقلة – دينية أو مدنية – تعيد صياغة الانتماء بمعايير الدولة، لا الطائفة.
الصمت الذي تمارسه بعض المرجعيات الكبرى تجاه النفوذ الإيراني والفساد هو مشاركة ضمنية في تدمير العراق.
أما المرجعيات “الولائية”، فهي تُشرعن الاحتلال الإيراني وتُجرّم الوطنيين.
الخاتمة: العراق بين الاستعادة أو الانهيار
لم تعد المسألة مسألة ولاءات سياسية فقط، بل صراع على هوية العراق نفسه.
إما أن يُستعاد العراق كدولة وطنية، سيدة القرار، موحدة الهوية، أو يستمر في التآكل تحت وطأة المرجعيات الطائفية والمشاريع الخارجية.
المطلوب:
• بناء خطاب وطني بديل، غير طائفي.
• إصلاح المؤسسة الدينية داخل العراق وتحريرها من نفوذ قم.
• إعادة الاعتبار للتربية الوطنية، وتطهير المناهج من التبعية.
• محاسبة الطبقة السياسية التي شرعنت الاحتلال الإيراني.
المراجع
1. منصور، ريناد. تحولات الشيعة في العراق بعد 2003. مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2021.
2. حسن، حارث. الدولة والمرجعية بعد صدام. معهد بروكنغز، 2019.
3. عبد الجبار، فالح. العمامة والأفندي: سوسيولوجيا المؤسسة الدينية الشيعية. المركز العربي، 2010.
4. Cockburn, Patrick. Muqtada Al-Sadr and the Battle for the Future of Iraq. Scribner,
2008
5. International Crisis Group. Iran’s Networks of Influence in Iraq. Report No. 217, 2020.
6. مقابلات وتحقيقات منشورة في “المدى”، “ناس”، “العالم الجديد”، “الحرة عراق”، 2019–2024.